اصطلح العالم وخاصة وسائل الاعلام الرئيسة على اعتبار منتصف سبتمبر الجاري الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الأزمة المالية العالمية التي أدخلت العالم في ركود اقتصادي هو الأسوأ منذ عدة عقود. وبهذه المناسبة تكثر التحليلات والتغطيات الإعلامية والتعليقات من المسؤولين والاقتصاديين والمستثمرين.
وتتضمن تلك التغطيات سردا للاحداث وتحليلا بوعي متأخر وتوقعات للمستقبل. لكن تبقى أسئلة كثيرة بلا إجابات حاسمة وشكوك حول وضع الاقتصاد العالمي على المديين القصير والمتوسط.
وفي حوار له بمناسبة ذكرى انهيار بنك ليمان براذرز الاستثماري الامريكي على تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الاميركي السابق آلان غرينسبان من أن الأزمة الاقتصادية ستتكرر، ويرجعها أساسا إلى “الطبيعة البشرية”.
ويبدو أن غرينسبان، الذي تولى مسؤولية السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم على مدى عقدين (رئيس الاحتياطي الفيدرالي من 1987 إلى 2006) يريد أن ينحي باللائمة بعيدا عن الجميع من سياسيين واقتصاديين في الحكومات والأسواق على حد سواء. ولأن الرجل لم يفقد تأثيره بعد، إذ يستشار من قبل الأميركيين والأوروبيين حتى الآن، فما يقوله هام جدا وفي الوقت نفسه خطير ـ إذ أنه يعني أن دروسا كثيرة من الأزمة الحالية لم تتم الاستفادة منها وأن إمكانية أي علاج جذري لتفادي تكرارها تبدو ضئيلة.
لعله من الممكن القبول بتحديد تاريخ انهيار واحد من أكبر أربعة بنوك استثمارية في العالم ليكون قمة هرم الأزمة المالية العالمية، إلا أن نذرها بدأت قبل ذلك بكثير وتمتد جذور اسبابها إلى أواخر القرن الماضي.
وإذا كان العالم يجمع الان على أن بداية تفاقم الأزمة هو انهيار قطاع العقار الأميركي منذ عام 2007، وما تلاه من أزمة القروض العقارية الرديئة، فإن الجذور تمتد في القطاع المالي إلى ثمانينات القرن الماضي مع بداية فورة السيولة في النظام العالمي وتباري المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية في ابتكار مشتقات وأدوات مالية غير تقليدية.
أما القطاع العقاري، في أمريكا والعالم، فقد كان العرض الطاغي في تلك العلة الاقتصادية العالمية. فما بين 2000 و2006 ارتفعت قيمة العقارات السكنية في الاقتصادات المتقدمة بما يقارب الضعف، لتصل قيمة القطاع السوقية إلى نحو 75 تريليون دولار، أي ما يزيد على الدخل القومي لتلك الدول في تلك الفترة.
وأصبحت هناك مغالاة شديدة في القيمة الحقيقية للأصول العقارية. وبالطبع تم تمويل تلك العمليات العقارية بالديون الهائلة التي ساعد على زيادة حجمها مع توافر ما يعرف بالأموال الرخيصة (أي نتيجة أسعار الفائدة المنخفضة)، وتسهيلات الإقراض والزيادة الهائلة في توريق الديون العقارية.
وفي أميركا، تعود أزمة فقاعة العقار إلى عام 1997، عندما أخذت أسعار العقارات في الارتفاع (وكانت أسعار الفائدة وقتها متدنية جدا، مما ساعد على بدء الغليان الذي أدى إلى الفقاعة). وارتفعت قيمة العقارات في اميركا بزيادة قدرها 12 تريليون دولار في تسع سنوات إلى 20 تريليون دولار. وتميزت فورة العقار في أميركا بالقروض العقارية غير المؤمنة تماما (اي قروض لأشخاص تاريخهم الائتماني سيء)، وتمكنت مؤسسات الإقراض من إعادة توريق تلك الديون عبر سندات ديون قصيرة الأجل عن طريق البنوك الكبرى التي سوقتها لصناديق الاستثمار في الديون في أنحاء العالم وخاصة في أوروبا.
ومع هبوط أسعار العقار في أميركا، انكشفت مراكز مستثمري الديون، خاصة البنوك الكبرى، على مخاطر بمليارات الدولارات، مما أدى إلى توقفها عن الإقراض ومطالبتها للمقترضين من المستثمرين بزيادة ضمانات السيولة عبر تسييل أصول استثمارية، حتى الجيدة منها.
ومع انفجار فقاعة العقار أصبحت تلك الرهون العقارية الهائلة ديونا معدومة، وبدأت البنوك والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار تحصي خسائرها. وبدأت النذر من بنك بي ان بي باريبا الفرنسي مطلع أغسطس/ 2007، ليتلوه مصرف يو بي إس الاستثماري السويسري.
وتوالت أخبار الكشف عن الخسائر والانهيارات من مصرف نورذرن روك العقاري البريطاني إلى أكبر شركتين للقروض العقارية الامريكية هما فاني ماي وفريدي ماك اللتان تديران 5 تريليونات دولار من الديون العقارية في الولايات المتحدة.
وقبل عامين دخل مصطلح جديد إلى لغة المال والأعمال والاقتصاد وهو الانكماش الائتماني Credit crunch حين توقفت البنوك عن الإقراض فيما بينها، وبدأت بقية قطاعات الاقتصاد تعاني من نقص أو انعدام القروض والاستثمارات اللازمة للإنتاج والتجارة. وتسارعت حلقة الانهيارات في القطاع المالي والمصرفي العالمي لتنكشف فقاعة السيولة الهائلة (بلغ إجمالي القيمة السوقية للأصول المالية في العالم في الفترة من 2004 الى 2006 نحو 100 تريليون دولار)
ولم يستطع المدافعون عن حرية السوق وأهمية القطاع المالي في الاقتصاد العالمي الرد على الانتقادات للمشتقات والأدوات المالية الجديدة التي كانت السبب الحقيقي في الأزمة.
ولم تفلح هنا الحكمة الاقتصادية التقليدية بأن الأسواق قادرة على حل مشاكلها بنفسها، وأن عمليات التصحيح الدورية كفيلة بتجاوز الأزمات الحادة.
وللحيلولة دون دخول الاقتصادات الرئيسية في كساد لا تفلح معه أي إجراءات ولا عمليات تصحيح (كما حدث في الكساد الكبير إبان ثلاثينات القرن الماضي) سارعت السلطات بضخ الأموال العامة في القطاع المالي والمصرفي وبقية قطاعات الاقتصاد. وجاء ذلك في شكل تأميم كلي أو جزئي للمؤسسات المنهارة وتقديم قروض دعم لأخرى وطرح كميات كبيرة من الأموال لتنشيط الاقتصاد، إلى جانب خفض سريع وكبير لأسعار الفائدة وإعفاءات ضريبية للشركات والأفراد. وبلغ إجمالي التدخلات الحكومية عالميا ما يصل إلى 18 تريليون دولار حتى الآن.
وبالطبع أدت تلك التدخلات الحكومية الهائلة إلى درء خطر الكساد والتخفيف من حدة الركود، وبدأت بعض الاقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا واليابان والبرازيل بالفعل في إبداء مؤشرات على التعافي في الربع الثالث من العام الحالى.
لكن ذلك يعود في أغلبه إلى تلك التدخلات الحكومية أكثر منه إلى طاقة توسع فائضة في تلك الاقتصادات. ولا تزال أزمة الائتمان قائمة حتى الآن ، وإن كانت أقل حدة. ويبدو القطاع المالي والمصرفي العالمي وكأنه يستعد للعودة إلى ممارسة نشاطه الكامل على أساس “عودة الامور الى مجاريها”. وهنا يكمن الخطر على التعافي الاقتصادي الهش حاليا، إذ أن “مجاريها” تلك هي التي سببت الأزمة. وإذا كانت الأسواق وقطاعات الأعمال تقاوم مسألة تشديد الإجراءات والضوابط واللوائح المنظمة لعملها فلا يجوز أن يجعل ذلك الحكومات تتردد في ضبط “مجريات الامور” وربما إعادة هيكلتها جذريا.
وكي يكون التعافي الحالي قويا ومستداما يتعين على الحكومات البحث بسرعة عن طريقة لوقف تدخلها وضخ الأموال العامة في الاقتصاد. بل يتعين أيضا رسم استراتيجية للخروج ، بمعنى سحب تدريجي وحذر لتلك الأموال من المنافذ التي ضخت فيها وكذلك البدء في تشديد السياسة النقدية.
ولا مجال للمبالغة في التخوف من أن ذلك قد يضر بالتعافي الهش ويأتي برد فعل عكسي يعمق الركود. فلم تكن تلك التدخلات وحدها وراء قدرة الاقتصاد العالمي على التعافي، وإن احتاج الأمر فلا بأس من إعادة النظر في ثقافة الأسواق والأعمال المالية إجمالا وبشكل جدي وسريع وليس بتراخ دولي على أساس أن الأزمة مرت بسلام. إذ إن التراخي قد يضر بالاقتصادات الصاعدة التي لعبت دورا باستمرار نموها خلال الازمة في التخفيف من حدتها.
وحسب الاحصائيات المتداولة فإنه مقابل انكماش بما تتراوح نسبته بين 2% و5 % في المتوسط السنوي في الاقتصادات الرئيسة التقليدية، فقد حافظت الصين وكثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثلا على نمو إيجابي ـ وإن تراجع النمو بنسبة كبيرة قد تصل إلى النصف في كثير من الحالات.
وعبر بعض الاقتصاديين عن مخاوفهم بأن مؤشرات التعافي تلك قد لا تزيد عن كونها “فجر كاذب” ويطالبون بضرورة التعامل معها بحذر. وفي حالة عدم اليقين تلك يصعب الحسم بأن الركود الاقتصادي العالمي قد أنهى أعماله وأن شبح الكساد مستبعد تماما.
وأبرز ما يجمع عليه غالبية الاقتصاديين ، وتعززه الشواهد من أرقام الاقتصاد الكلي وبيانات القطاعات المختلفة، أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تأتيان في ذيل الاقتصادات الرئيسة في مقياس التعافي، لأن كلا الاقتصادين البريطاني والامريكي يعتمدان في نمو الناتج المحلي الإجمالي على القطاع المالي أكثر من غيرهما وهو القطاع الذي بدأت منه الأزمة وكان الأكثر تضررا منه وبالتالى يظهر التاخر فى التعافى فى هذين الاقتصادين اقل من غيرهما .
والسؤال الذى يطرح نفسه هل تتكرر الازمة اذا تكررت نفس السياسات ؟ وهل استفاد العالم من هذه الازمة ؟
وهل لن يكرر من تسبب فى هذه الازمة فى تكرار نفس الاساليب والسياسات والاجراءات الاقتصادية ؟!!!
هل استفاد العالم من هذه الازمة ؟ ام من الممكن ان تتكرر الازمة !!!
سؤال انتظر الاجابة عليه منك …. عزيزى القارىء العربى .
بواسطة د. جمال شحات بتاريخ 14 سبتمبر 2009
|
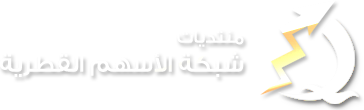




 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس